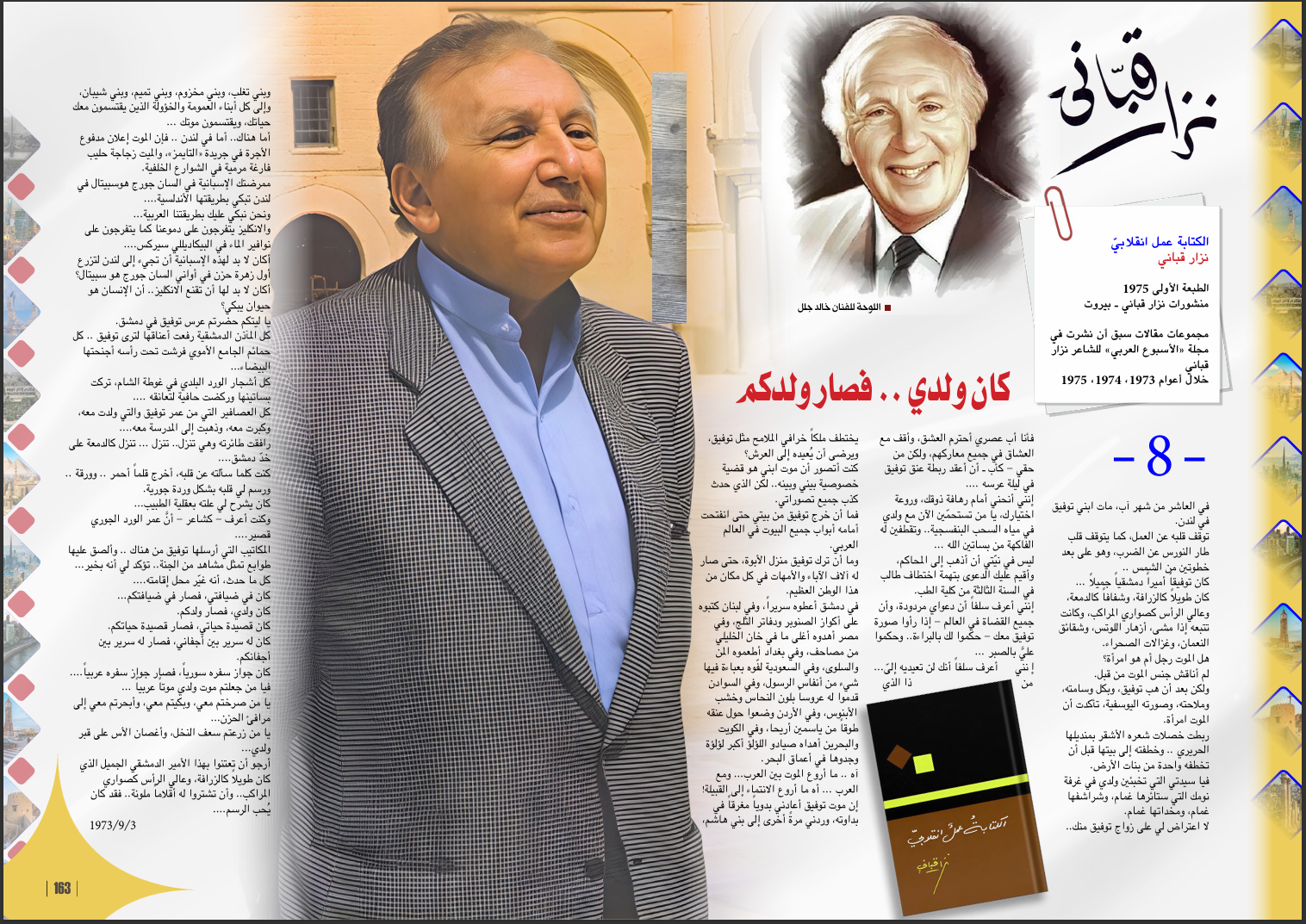أرواح مثقلة بالحزن

عبد الكريم البليخ
وكأني أبحث عن اكتشاف جديد بقدر ما كنت أبحث عن دهشة قديمة، دهشة توقظ الحنين الذي تراكم في صدري كتراب مدينة نسيها المطر. لكن الرحلة حملتني أبعد، إلى قلب أوروبا، إلى جمهورية التشيك وعاصمتها “براغ”، التي ما إن وطأتها قدماي حتى شعرت أن الزمن فيها يتثاءب، يتباطأ، أو ربما يتوقّف عمداً ليُطيل لحظة تأمل نادرة، كأن المدينة قررت أن تظل واقفة عند حافة العصور، رافضة أن تُبتلع في دوّامة الحداثة.
براغ، تلك التي كتب عنها كافكا ذات وجع: “هذه المدينة لا تترك أحداً يرحل منها بسهولة، بل تغلفه وتحتفظ به داخلها إلى الأبد.” كيف لرجل نجا من بيروقراطية الحياة وموت الروح أن يرى مدينته بهذا النور الحزين، لو لم تكن براغ تشبه قدراً لا مفر منه؟ مدينة الجسور والمئة برج، والمئة ناقوس، كما يسميها العشّاق والحالمون، تتكثف فيها الذاكرة حتى تفيض من حجارة الأرصفة، من زخارف الشرفات، من نوافذ البيوت المائلة قليلاً كأنها تتكئ على حكايات لم تُحكَ بعد.
يبدو أن براغ لم تتنازل، لم تخضع لغرور العصر. ولعلّ أكثر ما يدهشك حين تجوس طرقاتها هو هذا الانسجام العتيق بين البناء والإنسان، بين صمت الجدران وأصوات السياح. المدينة التي نالت لقب “المدينة الذهبية” لم تكن ذهبية فقط بل كانت مرآةً تعكس ألف عام من التاريخ، مرصوفة تحت قدميك، تنقلك بلا إنذار من قلاع العصور الوسطى إلى فن الباروك، ومن الأزقة الضيقة إلى الأبراج العالية التي تحرس المدينة كأنها تخشى أن يستيقظ الحلم فجأة وينهار.
لم تُصب براغ في حروبها بدمار شامل كما حدث لغيرها من مدن أوروبا، ولهذا ظلت أبنيتها كما كانت منذ قرون. هذا التفصيل وحده يكفي ليمنحها قيمة لا تضاهى، فالمكان حين لا تجرحه القنابل يظل شاهداً صادقاً على حكايات البشر. وبينما المدن الحديثة تبني ناطحات السحاب، تبني براغ ناطحات للذكرى، وتدعو زوّارها لأن يمشوا ببطء، كمن يمشي على أطراف حلم قديم.
في شوارعها القديمة، حيث الأرصفة الحجرية تنحت أقدام المارة وتخبّئ أنين العشّاق، شعرت أنني لا أريد شيئاً سوى أن أضيع. نعم، أضيع في الأزقة التي تشبه شرايين قلب ينزف حنيناً، أضيع في المقاهي الصغيرة التي تعبق بالقهوة والفلسفة، أضيع في الشرفات التي تفتح على سماء زرقاء لكنها ملبّدة بالحكايات. هنا، لا يكتفي الزائر بالمشاهدة، بل يتورّط. فبراغ ليست وجهة سياحية، بل فخّ جميل.
المدينة التي تنضح بجمال لا يشيخ، تُقدّم نفسها كملاذ لمن سئم شواطئ الشمس، وعاف صخب الاستراحات الصيفية. ففي براغ، كل حجر له ظل، وكل ظل له ماضٍ، وكل ماضٍ يشبهك، أو يخدعك بأنك كنت هنا من قبل. الإجازة الصيفية في هذه المدينة أشبه بخلوة مع التاريخ، خلوة مع الذات، حيث لا شيء يُطلب منك سوى أن تنصت.
**
لكن، ما إن يغيب هذا السحر خلف غيوم الحياة اليومية، حتى تبدأ المواجع بالتسلّل من جديد. بدأنا نعدّ الأيام والساعات، لا لأننا مللنا، بل لأن الزمن صار قاسياً، يشبه عربة مهترئة تجرّها أحصنة التعب. فوسط دفء المكان، تنهشنا برودة المشهد الداخلي. لم نعد نعرف أين نكون تماماً، نحن الذين تشظّت أرواحنا على أرصفة العالم.
تحدّي المكان، ولوعة الفقد، ووهم الأمل الذي نردده في مسامعنا كل صباح كأننا نشدّ أرواحنا من الهاوية… كلها صور تسكن الذاكرة ولا تغادر، ترفرف مثل أشرعة في مهب الريح، لا تعرف إلى أين تقودنا. وإن كنت ممن يحلم بتحقيق الذات، ويطمح للخلاص، فسرعان ما تُدرك أن الواقع غالبًا ما يقف حجر عثرة أمام كل أحلامك، يصفعك بيد لا تراها.
ما أقسى أن تجد نفسك في صالة انتظار، لا تنتظر طائرة، بل تنتظر خلاصك، كأنك عالق في نفق، تحاول أن تحتفظ بما تبقّى من متاعك: حقيبة صغيرة، صور، دفتر قديم، وربما فنجان قهوة لم تنهِه. وتتمنى في لحظة مريرة أن تتخلى عن كل شيء، أن تهرب من كل شيء، حتى من جسدك الذي صار عبئاً، أن تهرب إلى من تحب، إلى من يفهم صمتك، من يقرأ في عينيك دون أن تسأل.
الوحدة… تلك التي كنا نسمع بها، نستهجنها، نعتقد أنها من ترف العشّاق والشعراء، تحوّلت هنا، في بلاد الاغتراب، إلى شيء ملموس، إلى ظلّ دائم، إلى جدار تصطدم به كلما ظننت أنك اقتربت من الأمل. فالوحدة في أمريكا أو في أوروبا، ليست كالتي عرفناها في الخليج، حيث كنا نجد في البساطة عزاء، وفي الحنين سلوى، وفي دفء الأمكنة بعض الطمأنينة.
وكم من مغترب نطق بها صادقاً: “عرفنا كم نحب بلادنا، فقط حين غادرناها.”. لقد هجرناها مرغمين، مطعونين في القلب، لكن القلب ظلّ هناك، في الحارات القديمة، في ضجيج الأسواق، في طعم الشاي على السطوح، وفي أصوات المؤذنين وقت الغروب.
بلادنا تئن، مثخنة بالجراح، تصرخ من كل زاوية، تعاني من وجع لا يحتمله قلب، ومع ذلك، نشتاق. نشتاق رغم كل شيء، نشتاق لأننا نعرف أن الانتماء لا يُشترى، وأن الغربة، مهما بدت مبهرة، لا تطفئ هذا الحنين الخام الذي يسكننا.
**
لكن، نسأل ونحن نغرق في لجة هذا الحنين: لماذا الحزن سمة هذا الزمن العربي؟
لماذا تلاحقنا الكآبة حتى في بلاد تتزين بالجمال، وترتدي الفصول الأربعة بثياب بهيّة؟
هل الحزن قدرنا، أم أننا عشناه حتى صرنا نحترف التآلف معه؟
كم من مغترب في الولايات المتحدة أو في أوروبا يعيش على أطراف حلم لم يرده، حلم فُرض عليه، ثم تحوّل إلى واقع؟ أولئك الذين لم تكن أمريكا يوماً في حسبانهم، لا هاجساً ولا أمنية، لكنها صارت ملجأً، ومصيدة؟ كم منهم لم يحلم سوى بالفرار، فقط لأجل “الدولار”، وكم بقي لأجله فقط؟
الحكاية باتت بسيطة ومعقدة في آنٍ: لولا الدولار، لما بقي عربي مغترب في هذه البلاد دقيقة واحدة. كل من سألته، أجابني الجواب ذاته، كأنما اتفقوا عليه قبل أن يسألهم أحد. قالها أحدهم بمرارة:
“كله لأجل الدولار… وإلا فأنا أشتاق لتراب بلادي، حتى وإن كان موجوعاً”.
لكن أيّ ثمن ندفعه مقابل هذا الدولار؟ أيُّ روح نخسرها، وأيُّ حلم يُباع يومياً على أرصفة العمل، وفي أقبية المترو، ومناجم الضجر؟
هنا، في البلاد التي يحلم بها كثيرون، العمل لا يشبه العمل. هو التهام مستمر للوقت، للعمر، لكرامة الإنسان في كثير من الأحيان. الساعات تمتد، والملل يتضاعف، والجسد ينهك، والروح تتآكل. تظن أنك ستنجو فقط لو صبرت شهوراً، لكنها تتحوّل إلى سنوات، ثم إلى عمر كامل.
ثم تبدأ تكره هذا الحلم الوردي الذي بدا لك من بعيد كقصيدة، فإذا به عند الاقتراب، وثيقة نفي مؤبّدة. تعيش، لكنك لا تحيا. تعمل، لكنك لا تزدهر. تضحك، لكنك لا تفرح. غريب، حتى في أقرب الأماكن إلى قلبك.
**
وفي النهاية، يعود السؤال ليطرح نفسه، بلا إجابة حاسمة:
هل السياحة، وهل الدولار، وكل زخارف العالم، تكفي لشفاء هذا القلب العربي الكسير؟
هل براغ بكل أبراجها، ونيويورك بكل أبراجها، قادرتان على أن تحملا عنك ثقل الغربة؟
ربما… وربما لا.
لكنّ ما أعرفه، أن الروح لا تشفى إلّا إذا عادت إلى وطنها.
حتى لو كان الوطن جريحاً.
26/7/2025