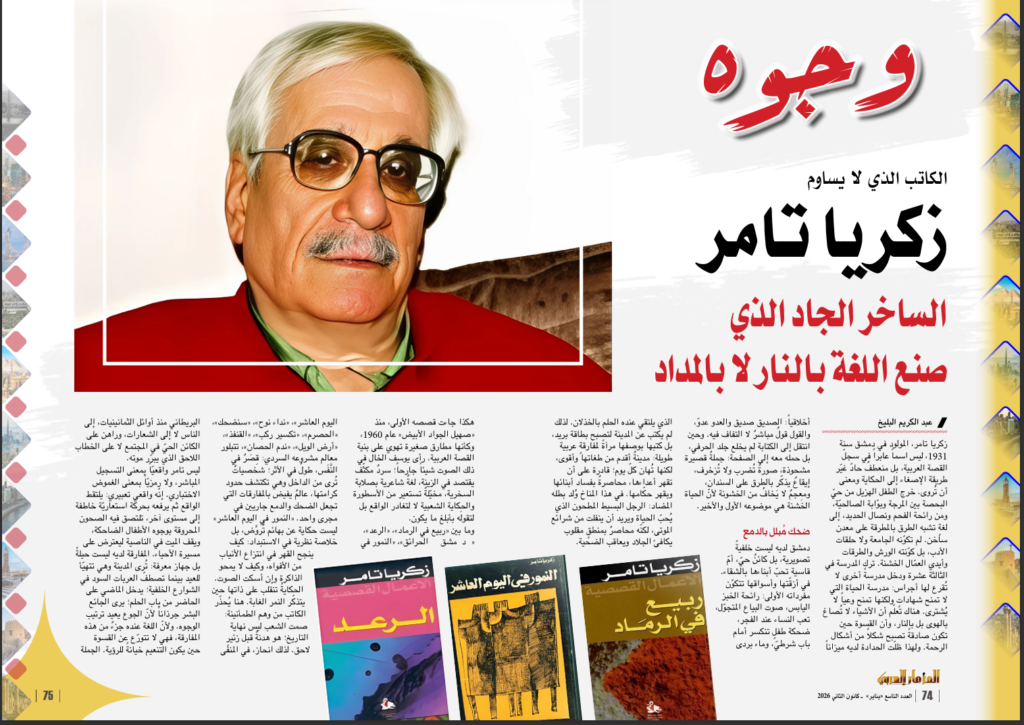أثره ظلّ باقياً لا يُمحى في وعي القارئ العربي
عبد الكريم البليخ
زكريا تامر، المولود في دمشق سنة 1931، ليس اسماً عابراً في سجلّ القصة العربية، بل منعطفٌ حادّ غيّر طريقة الإصغاء إلى الحكاية ومعنى أن تُروى. خرج الطفل الهزيل من حيّ البحصة بين المرجة وبوّابة الصالحيّة، ومن رائحة الفحم ونصال الحديد، إلى لغةٍ تشبه الطرق بالمطرقة على معدن ساخن. لم تكوّنه الجامعة ولا حلقات الأدب، بل كوّنته الورش والطرقات وأيدي العمّال الخشنة. ترك المدرسة في الثالثة عشرة ودخل مدرسةً أخرى لا تُقرع لها أجراس: مدرسة الحياة التي لا تمنح شهاداتٍ ولكنها تمنح وعياً لا يُشترى. هناك تعلّم أن الأشياء لا تُصاغ بالهوى بل بالنار، وأن القسوة حين تكون صادقةً تصبح شكلاً من أشكال الرحمة. ولهذا ظلّت الحدادة لديه ميزاناً أخلاقياً: الصديق صديق والعدو عدوّ، والقول قولٌ مباشرٌ لا التفاف فيه. وحين انتقل إلى الكتابة لم يخلع جلد الحرفي، بل حمله معه إلى الصفحة: جملةٌ قصيرة مشحوذة، صورةٌ تُضرب ولا تُزخرف، إيقاعٌ يذكّر بالطرق على السندان، ومعجمٌ لا يَخافُ من الخشونة لأنّ الحياة الخَشنة هي موضوعه الأول والأخير.
ضحك مُبلل بالدمع
دمشق لديه ليست خلفيةً تصويرية، بل كائنٌ حيّ، أمّ قاسية تحبّ أبناءها بالشقاء. في أزقّتها وأسواقها تتكوّن مفرداته الأولى: رائحة الخبز اليابس، صوت البياع المتجوّل، تعب النساء عند الفجر، ضحكة طفلٍ تنكسر أمام باب شرطيّ، وماء بردى الذي يلتقي عنده الحلم بالخذلان. لذلك لم يكتب عن المدينة لتصبح بطاقة بريد، بل كتبها بوصفها مرآةً لمفارقةٍ عربية طويلة: مدينةٌ أقدم من طغاتها وأقوى، لكنها تُهان كلّ يوم؛ قادرة على أن تقهر أعداءها، محاصرةٌ بفساد أبنائها وبقهر حكّامها. في هذا المناخ وُلد بطله المضاد: الرجل البسيط المطحون الذي يُحبّ الحياة ويريد أن ينفلت من شرائع الموتى، لكنّه محاصرٌ بمنطقٍ مقلوب يكافئ الجلاد ويعاقب الضحية. هكذا جاءت قصصه الأولى، منذ «صهيل الجواد الأبيض» عام 1960، وكأنها مطارق صغيرة تهوي على بنية القصة العربية. رأى يوسف الخال في ذلك الصوت شيئاً جارحاً؛ سردٌ مكثّف يقتصد في الزينة، لغةٌ شاعرية بصلابة السخرية، مخيّلةٌ تستعير من الأسطورة والحكاية الشعبية لا لتغادر الواقع بل لتقولَه بأبلغ ما يكون.
القاص والصحافي زكريا تامر
وما بين «ربيع في الرماد»، «الرعد»، «دمشق الحرائق»، «النمور في اليوم العاشر»، «نداء نوح»، «سنضحك»، «الحصرم»، «تكسير ركب»، «القنفذ»، «أرض الويل»، «ندم الحصان»، تتبلور معالم مشروعه السردي: قِصَرٌ في النَّفَس، طولٌ في الأثر؛ شخصياتٌ تُرى من الداخل وهي تكتشف حدود كرامتها، عالمٌ يفيض بالمفارقات التي تجعل الضحك والدمع جاريين في مجرى واحد. «النمور في اليوم العاشر» ليست حكاية عن بهائم تُروَّض، بل خلاصة نظرية في الاستبداد: كيف ينجح القهر في انتزاع الأنياب من الأفواه، وكيف لا يمحو الذاكرة وإن أسكت الصوت. الحكايةُ تنقلب على ذاتها حين يتذكّر النمر الغابة. هنا يُحذّر الكاتب من وهم الطمأنينة: صمت الشعب ليس نهاية التاريخ؛ هو هدنةٌ قبل زئيرٍ لاحق. لذلك انحاز، في المنفى البريطاني منذ أوائل الثمانينيات، إلى الناس لا إلى الشعارات، وراهن على الكائن الحيّ في المجتمع لا على الخطاب اللاحق الذي يبرّر موته.
ليس تامر واقعيّاً بمعنى التسجيل المباشر، ولا رمزيّاً بمعنى الغموض الاختباري. إنّه واقعي تعبيري: يلتقط الواقع ثم يرفعه بحركة استعاريّة خاطفة إلى مستوى آخر، تلتصق فيه الصحون المحروقة بوجوه الأطفال الضاحكة، ويقف الميت في الناصية ليعترض على مسيرة الأحياء. المفارقة لديه ليست حيلةً بل جهاز معرفة: تُرى المدينة وهي تتهيّأ للعيد بينما تصطفّ العربات السود في الشوارع الخلفية؛ يدخل الماضي على الحاضر من باب الحلم؛ يرى الجائع البشر جرذاناً لأنّ الجوع يعيد ترتيب الوجوه. ولأنّ اللغة عنده جزءٌ من هذه المفارقة، فهي لا تتورّع عن القسوة حين يكون التنعيم خيانةً للرؤية. الجملة القصيرة عنده ليست بخلاً بل أمانةٌ في الصنعة: لا يكتب ما لا ضرورة له، وخواتيمه تُغلق المشهد فجأةً كما تُسدل الستارة في المسرح، تاركةً الرجْع يعمل عمله في صدر القارئ.
ولأنه قاصّ وصحافي في آن، فإنّ حساسيته للواقع لا تتجمّد داخل الاستعارة. في عموده الرمزي الساخن ـ الذي مزج فيه لُغة الحكاية ومجاز السياسة ـ نقرأ «قال الملك لوزيره» كدرسٍ مستمرّ في علاقة السلطة بالناس: ملكٌ حزين يريد حبَّ شعبه فيغلق المدارس ويحرق الكتب ويعتقل الشعراء، ثم يُبشَّر بعد عام بأنّ الجميع يحبّه لأنهم لا يتكلّمون؛ وزيرٌ يشتري الصمت بالأمان؛ رعيّةٌ تُطعَم الخوف كما تُطعَم الدجاج الحبوب. هذه المقالة ـ بما تشبهه من أمثالٍ وحِكَمٍ مرَكّبة ـ هي الوجه الصحافي لذات الرؤية القصصية: إن قمع التفكير أصلُ البلاء، وإنّ الكرامة لا تُمنَح بل تُنتَزع، وإنّ اللغة التي لا تُغضِب أحداً لا تُفرِح أحداً أيضاً. والكتابة، كما يردّد، فعلُ تمرّد قبل أن تكون صنعةَ تسلية.
لا يتهرّب تامر من الممنوعات؛ يقتحم السياسة والدين والجسد، لا باعتبارها موضوعات صادمة بل بوصفها ساحات قهرٍ مرئيّة في الاجتماع العربي. في نصوصه نرى كيف يُستدعى الدين لتسكين الأسئلة وتحويلها إلى طاعة، وكيف تتحوّل الأخلاق إلى سوطٍ في يد الرقيب، وكيف تُدار الدولة بمنطق إعلان الحرب على الأعراض لا معالجة الأسباب. في محاكمه الرمزية يُدان عمر الخيام لأن الرباعيات «تحرّض على استيراد الخمرة الأجنبية» في بلدٍ يحلم بالاكتفاء الاقتصادي، وتُعدّ «قلة المديح» دليلاً على «كراهية الشعب». هذا المنطق المقلوب، حيث القبح معيارُ الجمال والهزيمةُ مغمورةٌ بالرايات، هو ما يعريه السرد. ولهذا تبدو السخرية السوداء في قصصه ضرباً من التبصير: إنّها ليست إضافةً طريفة، بل مجهرٌ يكشف المفاصل التي يُمسَك المجتمع منها.
المرأة في عالمه ليست ملحقاً سرديّاً، بل مركز أخلاقيٌّ وجماليّ. هي الجسد المراقَب باسم الطهارة، والصوت المقطوع باسم الشرف، والروح التي تتذكّر صفعة الأب وهي تقف أمام القاضي أو الطبيب. غير أنّها ليست ضحيةً صامتة؛ إنها رغبةٌ تعود إلى نفسها كي تنتقم من منظومةٍ تخلط بين الفضيلة وإهانة الإنسان. وهكذا، حين يظهر الجسد في نصّه لا يظهر لإثارةٍ مجّانية، بل لكي يقيس شدّة القمع الاجتماعي الذي يعجن الشهوة بالعنف ويصوغ من الوصايا أخلاقًا تُهين الجسد والرغبة والروح جميعاً. والطفل أيضاً ليس أيقونة براءة فحسب، بل مقياسُ اختلالٍ اجتماعي: غالباً ما يُفتَرَس رمزيّاً، أو يُقاد بسلسلةٍ من عنقه، ومع ذلك يبقى حاملاً لبذرة الخيال الذي ينقذ. الأطفال يخرجون من الكتب ليشربوا القهوة ويُحوّلوا المذكرات إلى زوارق وطائرات، في استعارةٍ جارحة عن القراءة بوصفها انبعاثاً لا هروباً.
كتابة الأطفال عند تامر امتدادٌ طبيعيّ لأخلاق الكتابة عنده: لا يتحدّث إلى الصغار باعتبارهم ناقصي الأهلية، بل بوصفهم قرّاء يحقّ لهم أن يعرفوا العالم كما هو، مع جرعة الحلم اللازمة للنجاة منه. في «لماذا سكت النهر؟» لا يسكت النهر لأنّ الشتاء قاسٍ، بل لأنّ أحدًا أسكته؛ وفي «قالت الوردة للسنونو» تتكلّم الطبيعة ليُصغي الصبيّ إلى ما هو أكبر من الكبار. هكذا تصبح حكاياته للصغار تمارين في الحرية والخيال معاً، لا تعليباً للموعظة.
جمال بلا أقنعة
ولأنّه «حدّاد كلمات»، فالسرد عنده صناعة أخلاقية قبل أن يكون جمالاً لغوياً. لا يبيع للقارئ بضاعة مغشوشة، ولا يزخرف الواقع بما ليس فيه. يكتب ليجعلنا شهوداً لا سيّاحاً، ويُدخل القارئ في التجربة بدل أن يُقدّمها له من وراء زجاج. لذلك، حين تنتهي قصّته، لا يمنحك الحكمة جاهزةً ولا يترك ملخّصاً مريحاً، بل يخرج ويتركك مع السؤال. والقارئ الذي يطلب «الخلاص» منها يكتشف أنّ الخلاص ليس من شأن الأدب، بل من شأن الفعل. الأدب هنا يعلّق مرآةً على جدار الزمان، يريك وجهك كما هو: متعبًا، متمرّداً، قادراً على الضحك، مخذولاً أحياناً، لكن ما يزال قادراً على أن يقول «لا».
في الصحافة الثقافية، عمل وتحرّر وحرّر، في دمشق ولندن، وشارك في تأسيس اتحاداتٍ وهيئاتٍ أدبية، ورأس أو شارك في تحرير مجلاتٍ عربية، وتولّى مسؤولياتٍ ثقافيةً وإعلامية، لكنه ظلّ حريصاً على المسافة بين الوظيفة والصوت، بين منصب الثقافة وثمنه. لا يعنيه البريق بقدر ما يعنيه أن تظلّ الجملة صادقةً، وأن يظلّ القارئ مخاطَباً لا مخدوعاً. حين تنفجر الأحداث الكبرى ـ سواء في بلده أو في مدنٍ عربيةٍ أخرى ـ لا يلجأ إلى البلاغة الطارئة، بل يعود إلى قاموسه القديم: الحرية، الكرامة، الخوف، السخرية التي تكشف ولا تُخدِّر، الإيمان بأنّ الإنسان قد يُروَّض لكنه لا يُمسَخ إلى الأبد.
والتجربة السياسية والفكرية عنده ليست لافتةً أمام النصّ، بل روحٌ في داخله. عندما تعرّضت المنطقة لزلازل أخلاقية وسياسية، اختار الوضوح الصعب: مع الحرّية ضدّ الاستبداد، بلا استثناءاتٍ ولا هوامش للمساومة. اختار الابتعاد عن الأضواء لا الابتعاد عن الموقف، واختار قلّة الظهور لا قلّة الشجاعة. لهذا ظلّت سيرته الشخصية فقيرةً بالتفاصيل الصاخبة، غنيّةً بالمبادئ التي يمكن قراءتها في قصصه كما تُقرأ في مواقفه.
وليس غريباً أن يجد النقّاد فيه شاعرَ القصة العربية: لغته المكثّفة هي شعرٌ يُروى نثراً، وصوره تعمل عمل المجاز الحيّ، وموسيقاه الداخلية تنبع من علاقة دقيقة بين الكلمة والفكرة والإيقاع. حين يقول في ختام مشهدٍ دمشقيّ إنّ رجلاً «ألصق ظهره بالحائط وأصابعه تمسك الرغيف بضراوة»، لا يقدّم مشهداً واقعياً وحسب، بل يقدّم بنيةً سياسيّةً كاملة: الحائط سلطةٌ وجدارُ خوف، والرغيف كرامةٌ وحقٌّ بسيط، والضراوةُ التي يُمسَك بها الرغيف احتجاجٌ صامت. هذه البلاغة الصامتة هي جوهر فنه: لا تحتاج إلى صراخٍ لتقول كلّ شيء.
في تلقّي الأجيال اللاحقة له، ستجد كتّاباً كثيرين يعلنون أثره فيهم: فكرة التكثيف، الجملة القاطعة، المفارقة التي تربط الضحك بالألم، الجرأة في اقتحام ما سُمّي طويلاً بالمحرّمات، إعادة الاعتبار للحكاية الشعبية بوصفها أداة تفكير لا وعاء تسلية. ومع ذلك ظلّ بعيداً عن فكرة «المدرسة» التي تُستنسخ؛ لأنّ سرّه ليس في القالب بل في أخلاق الصنعة: في أن تكتب لأنك لا تستطيع إلا أن تقول الحقيقة كما تراها، ولو جرحت يدك بالمطرقة.
أما ترجماته وجوائزه، فليست سوى آثارٍ جانبية لمسيرةٍ جعلت النصّ معياراً وحيداً. تُرجمت قصصه إلى لغاتٍ كثيرة، ونال جوائز مرموقة، لكنه لم يتغيّر: بقي الحرفي القديم الذي لا يحبّ الاحتفالات ولا التصفيق. الوسام الحقيقي عنده أن يعود القارئ إلى البيت مختلفاً عمّا خرج: أن يشعر بأنّ شيئاً في رأسه قد أُعيد ترتيبه، وأنّ شيئاً في قلبه صار أكثر يقظة.
الذين يضعونه في خانة التشاؤم يغفلون عن طبقةٍ أخرى في نصّه: الأمل المتخفّي على هيئة ضحكٍ مرّ. «سنضحك» عنوانٌ وموقف؛ ليس وعداً بخفّةٍ غافلة، بل تدريباً على النجاة. الضحك هنا ليس قناعاً للهروب بل وسيلةً لخلق مسافةٍ مع القبح كي لا يُحطّمك. الضحك مقاومة، مثلما السخرية معرفة: كلاهما يحفظان إنسانك من الانكسار النهائي. وهكذا لا يعود الأدب ترفاً، بل تمريناً على البقاء آدمياً في عالمٍ يُصرّ على دفعك إلى ما دون الإنسان.
وحين ننظر إلى بنيته السردية من الداخل سنجد اقتصاداً محسوباً في الحوار، وروايةً تميل إلى الراوي العليم الذي يتنازل فجأةً عن مسافته ليطلّ بـ«أنا» مفزعة: طفولةٌ تتلقّى صفعة الأب لأنّ ثوبها انحسر قليلاً؛ رجلٌ ينهشه الجوع حتى يرى البشر جرذاناً؛ امرأةٌ تتوسّل إلى المعتوه أن يعضّ لحمها كي تقيس شدّة قمعها. ليست هذه غرائبياتٍ مصنوعة، بل استعاداتٌ مكثّفة لواقعٍ يخلط الشهوات بالعقوبات، ويصنع من «الفضيلة» آليةً لإهانة الجسد والروح.
من هذه الزاوية يمكن فهم علاقته بالموروث: لا يستحضره لكي يزخرف النصّ أو يخفّف من حدّته، بل لكي يقلب الدلالات ويجعل الرموز القديمة تنطق في حاضرٍ يظنّ نفسه بلا جذور. شهرزاد ليست مطمئنةً إلى حمايات القصر؛ هي حافظَة سرّ الحرف الوهّاج، وعبد الله بن المقفع يعود في نسخة ثالثة لينازع السيف على معنى التفكير. إنّها عملية «أسطرة معاكسة»: تحويل الواقع إلى أسطورةٍ للإيضاح لا للإبهام، وإعادة الأسطورة إلى واقعٍ يذكّرنا بأنّ تاريخ القهر واحد وإن اختلفت بزّاته.
هل كان ممكناً أن يكتب على هذا النحو لو لم يمرّ بسنوات الحدادة؟ ربما، ولكن الأكيد أنّ اليد التي جرّبت النار في الحديد تعرف كيف تصنع ناراً من كلمات. إنّ دقّة المشغول، وصرامة الاختيار، والاقتصاد في الزوائد، كلها صفاتُ حرفيّ ماهرٍ قبل أن تكون صفات كاتب. لذلك يبدو المشهد القصصي عنده منحوتاً أكثر مما هو مكتوب: كلّ ضربةٍ زائدةٍ تُفسد التكوين، وكلّ سطرٍ متمهّلٍ لا ضرورة له يطفئ شرارة الصورة.
توهج المعدن الإنساني
على امتداد أكثر من نصف قرن، ظلّ يطرق أبواب الوعي العربي من غير ضوضاء، ويلتفت عن الأضواء إلى النصّ، وعن التعريفات إلى التجربة. لم يحتج إلى تمثالٍ في ساحة المدينة؛ تمثاله قائمٌ في نحوٍ جديد من السرد العربي، وفي قارئٍ تعلّم من قصصه أن الحكاية ليست «قصّة حدثٍ»، بل «حدثُ وعي». وحين نسأله «أين أنت؟» لا نحتاج إلى عنوانٍ أو نشيد. إنّه في مكانٍ يتكرر في نصوصه: عند الجدار الذي يُلصَق به الظهر، وعند الرغيف الذي يُمسَك بضراوة، وعند الضحكة التي تخرج مبلّلةً بالدمع لكنها تخرج، وعند الجملة القصيرة التي تُقال بلا مواربة ثم تتركك لتكمّلها أنت بحياتك.
إنّ زكريا تامر، القاصّ والصحافي، هو المثال النادر على اتحاد الموقف والفنّ في شخصٍ واحد. يُعلّمنا أن السخرية ذروة الجِدّ، وأنّ الحكاية الشعبية يمكن أن تكون سلاحًا فلسفيًا دقيقًا، وأنّ الحدادة هي التعريف الأكثر أمانةً للأدب: صهرُ قسوة العالم في قالبٍ من جُملٍ قليلة، ثم طرقُ القارئ بها مرّةً بعد أخرى حتى يتوهّج المعدن في داخله. هناك، في توهّج المعدن، يبدأ التغيير الذي لم تتعهّد به أيّ سلطة، ولم تمنحه أيّ مدرسة؛ تغييرٌ يصنعه الأدب حين يبقى وفيًّا للحياة، وقاسيًا على الزيف، وشجاعاً في تسمية القبح باسمه، وحنوناً في حماية ما تبقّى من إنسانٍ في الإنسان. بهذه الخلاصة يمكن أن نقرأ تامر اليوم وغداً: كاتباً يحرس الوعي من الخدر، ويُذكّرنا بأنّ النمر قد ينام طويلاً، لكنه لا ينسى الغابة.