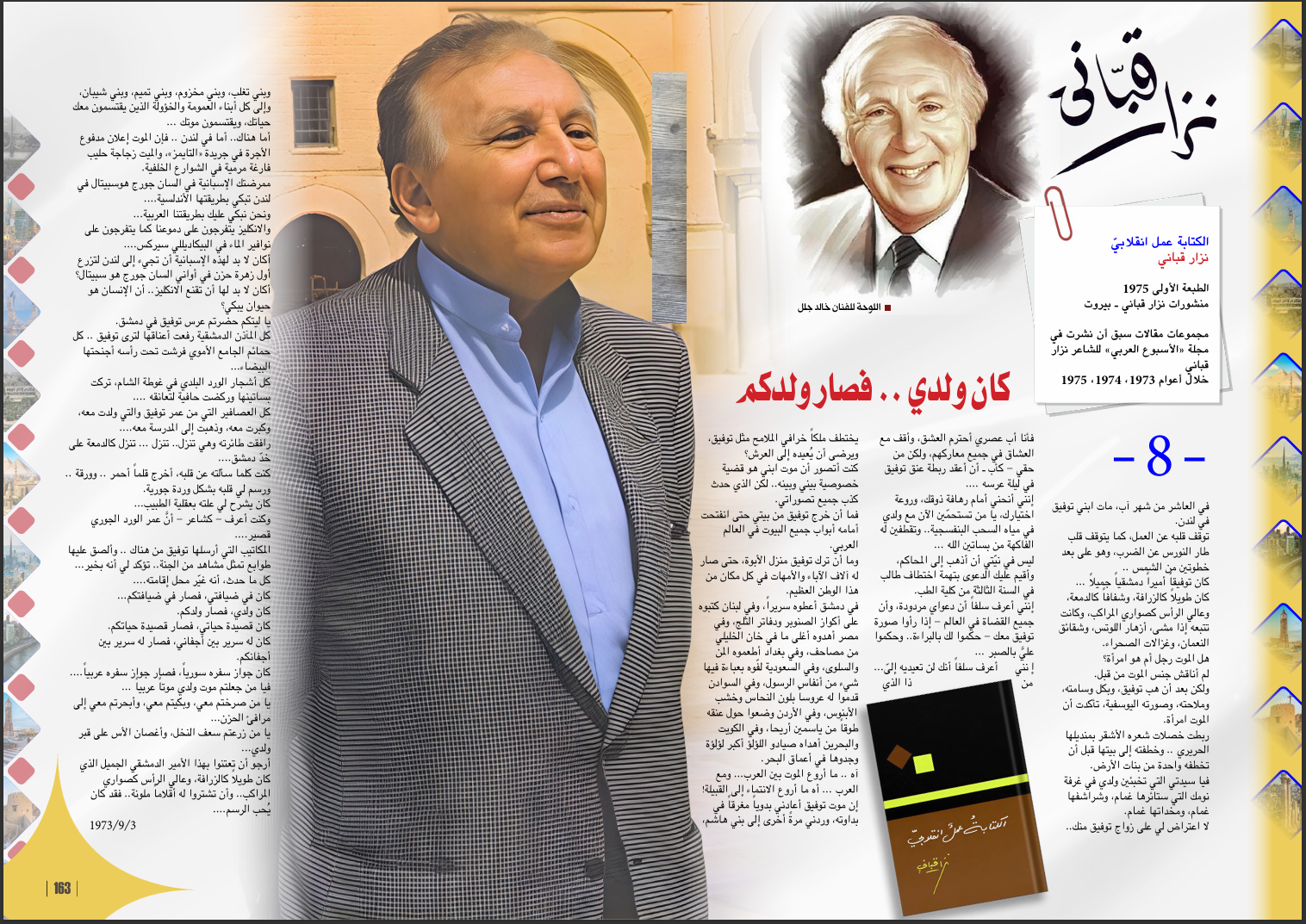في وداع د.عبد الكريم يوسف

د. موسى الحالول

قرأت مقتطفَ “أما الأحِبَّةُ فالبيداء دونَهُمُ” من قصيدة المتنبي الشهيرة وسمعته عشرات المرات، ولم يُبْكِني إلا مرةً واحدةً (ولعلها أن تكون الأخيرة). ثم أسعفتني ـ بل أسعدتني ـ ابنتي الصغرى ريم بالبكاء أيضاً ـ من باب “إن الشَّجا يبعث الشَّجا”. كان ذلك في 22 تشرين الثاني 2025 حين وردني، من طريق الصديق العزيز د. هيثم فرحت، مقطع فيديو للصديق العزيز الآخر د. عبد الكريم يوسف، وهو على فراش الموت في مدينة سِدني الأسترالية. كان يُنشِد أبيات المتنبي ويغالب دموعه، وابنه الصغير الوحيد ورد ينزوي على كرسي غيرَ بعيدٍ عنه. كانت تلك أول مرة أرى فيها دموع عبد الكريم. لا بد أنها كانت لحظة حزن استثنائية.
رأيت عبد الكريم في اللاذقية وحلب والرّقة والطائف وجِدَّة عشرات المرات ضاحكاً أو غاضباً أو ناقماً على هذا الوضع أو ذاك، لكني لم أره في مثل هذا الضعف العاطفي إلّا هذه المرّة. ولعلّ ما زاد من حزني عليه هو أنني أراه في مقطع فيديو، وبيني وبينه فرق توقيت هائل ـ ثماني ساعات بين إسطنبول وسِدني ـ وألوف الكيلومترات. فلا سبيل إلى رؤيته ولا إلى مواساته في ساعات العُسرة تلك. أدركتُ أن ساعة فِراقه قد دَنَت، ما لم تحدث معجزة ربانية تنقذه من سرطان الدم الذي نخر جسده وعظامه وأحاله إلى ما يشبه الهيكل العظمي منذ علمي بمرضه في الصيف الماضي. أرسلت إليه رسالة بالواتس أب، ولم يردني منه جوابٌ عليها.
وداع مؤجل دائماً
منذ أن رأيت عبد الكريم آخر مرة في صيف 2011 حين زارني في الرّقة مع صديق آخر، لم نتحدث بالهاتف إلا مرةً واحدةً، وذلك في الصيف الماضي حين أعلمني هيثم أن صديقنا الحبيب أُصيب بسرطان الدم. وحين تحدثنا، كان لدينا كلينا أمل أن نلتقي في سوريا “ونقعد ونشوف بعض ونحكي”، كما قال لي بصوتٍ واهنٍ من المستشفى.
كان هيثم يرسل إليَّ ما يصله من زوجة عبد الكريم من مقاطع فيديو ترصد تطور حالته الصحية. في أحد المقاطع، بدا عبد الكريم مطمئنَ النفس، مستسلماً لقضاء الله وقدره، ويردد مقطوعةً من الشعر (لا أدري إن كانت من نظمه أم من نظم غيره) يتحدث فيها عن الموت الذي شبَّهه بالغفوة:
نَم في الحياةِ فإنما دربُ الحياة هوىً وغِيُّ … هي غفوةٌ ترتاح فيها النفسُ ضيَّعها الغبيُّ
النومُ من شيمِ الكرامِ وليس يعرفه الغبيُّ …
ثم تلا عجزَ البيت الأول مرةً أخرى، جاعلاً إيّاه عجزاً للبيت الثاني، ثم أدرك أنه أخطأ في ذلك وقال، “لا، نسيت والله”. أن ينسى عبد الكريم شطرَ بيت من الشعر يعني أن صحته وذاكرته قد تدهورتا إلى حد مقلق. كان عبد الكريم معروفاً بين أصدقائه وأهله ومحبيه بأنه صاحب ذاكرة مثقوبة عجيبة إلا فيما له علاقة بالشعر، إذ ظل حتى بعد أن تجاوز الخمسين يحفظ الأناشيد التي تعلمها في المدرسة الابتدائية. ولعل السر في ذلك هو أنه كان شاعراً مطبوعاً، ومن القليلين الذين لديهم أذن موسيقية تستطيع التقاط أي خلل في الوزن إذا تورطتَ وتلوتَ أمامه قصيدةً من ذاكرتك!
كان المتنبي شاعرَه المفضل، ويعرف سيرته خيراً من أي شاعر آخر. ومنه علمت أن كُنْيةَ أبي الطيب الأقلَّ شهرةً هي أبو مُحَسَّد. وكان يعزي نفسه في أثناء مرضه بتلاوة قبساتٍ من فيوض صاحبه وقدوته في الشعر. في أحد مقاطع الفيديو، كان عبد الكريم يردّد قول المتنبي:
وَرْدٌ إِذا وَرَدَ البُحَيرَةَ شارِباً … وَرَدَ الفُراتَ زَئيرُهُ وَالنيلا
هنا كان عبد الكريم يُلمِّح إلى ابنه ورد أيضاً في هذا الاستذكار المؤلم. وأظنه كان يُلقن ابنه حب الشعر والعربية والمتنبي معاً بربط اسمه بقصيدة المتنبي هذه. ففي أستراليا، كان عبد الكريم هو من يدرِّس ابنه اللغة العربية.
وُلِد عبد الكريم حامد يوسف في مدينة حمص في سنة 1953، والتحق بجامعة دمشق لدراسة الأدب الإنجليزي. وبعد التخرج أدى خدمته العسكرية الإلزامية في أمن الدولة، وقد درس اللغة العبرية في دورة الأغرار. ثم عمل مُدرساً للغة الإنجليزية في الكويت مدةً من الزمن قبل أن يلتحق بقسم اللغة الإنجليزية بجامعة تشرين (اللاذقية الآن) بصفة معيد. أُوفِد بدايةً إلى الهند التي بقي فيها بضعة أشهر فقط (عدَّها سياحةً لا دراسةً)، ثم عاد إلى سوريا، ثم التحق بجامعة إسِكس البريطانية، وتخصَّص في الأدب المقارن. بعد عودته من الإيفاد، أمضى بضع سنوات في سوريا قبل أن يسافر في عام 1996 إلى أستراليا التي بقي فيها عامين. وبعد أن حصل على جنسيتها عاد إلى سوريا بعد جولة سياحية في أمريكا الشمالية واليابان وبريطانيا. ولما تقاعد من جامعة تشرين، عاد إلى أستراليا ـ عودةً لم يكن يرجو ألا تكون منها عودةٌ إلى مسقط رأسه وألا تحول بينه وبين الأحَبة بِيْدٌ دونها بِيْدُ!
حين التحقتُ معيداً بقسم اللغة الإنجليزية بجامعة تشرين في عام 1988، كان عبد الكريم موفداً في بريطانيا، وحين عدتُ من الإيفاد من الولايات المتحدة في صيف 1995، التقيتُه لأول مرة. وبعد شهرين أو ثلاثة من بداية العام الدراسي، عرض عليَّ أن يستضيفني في بيته بدلاً من أن أستأجر. وفعلاً، هذا ما كان، فتوطدت صداقتنا، وشكَّلنا أنا وهو وهيثم “ثالوث العُزَّاب” في القسم. وقد أتاح لي سكننا معاً فرصةً نادرةً لمعرفته من قرب.
كان عبد الكريم كريماً، متواضعاً، نزيهاً، محارباً للظلم والفساد، محبًا للفكاهة والمرح، يكره التصنع والمظاهر الجوفاء (لم يلبس بدلة رسمية أو ربطة عنق قط)، قارئاً نهماً (وخاصةً للشعر العربي)، غير عابئ بالترقيات الوظيفية والمناصب الإدارية. وكان فوق ذلك كله نَسَّاءً لم أرَ ولم أسمع بأحدٍ له مثل ذاكرة عبد الكريم المثقوبة.
نسيان مضحك
حين التحق عبد الكريم بإحدى الجامعات الأردنية الخاصة (لعلها جامعة جرش الأهلية)، استدعته المخابرات الأردنية من أجل مسح أمني روتيني. وهناك سأله الضابط إن كان أحد من أقربائه أو أصهاره في الجيش أو أجهزة الأمن السوري. قال للضابط: “نعم، صهري عقيد في الجيش”. طلب منه الضابط أن يُعطيه اسم صهره من “أربع مقاطع” فقال له عبد الكريم: “أبو بسام”. قال له الضابط، “لا، نحن نريد اسمه وليس كنيته”. حاول عبد الكريم أن يتذكر اسم صهره وحاول من غير جدوى، وخرج من عند الضابط بعد أن وعده بأن يأتيه باسم صهره متى تذكره. ولم يتذكره إلا بعد أن سأل أخته عن اسم زوجها العقيد أبو بسام!
وفي إحدى السنوات، كان يدرِّس في جامعة البعث (حمص حالياً) بصفة أستاذ زائر. وبعد نهاية الامتحانات، ذهب من اللاذقية إلى حمص لاستلام دفاتر امتحانات المادة التي درَّسها من أجل تصحيحها وإعادتها للجامعة. ولما ذهب إلى دائرة الامتحانات في كلية الآداب اكتشف أنه قد وقَّع على استلامها منذ مدة. فظن أنه ربما نسيها في بيت أهله في حمص، فلما فتش هناك، لم يجدها. وهنا أيقن أنه لا بد أنه أخذها إلى بيته في اللاذقية ونسيها هناك. توجَّه إلى محطة الباصات ليعود إلى اللاذقية، وسأل موظفة الحجز في إحدى الشركات: “عندكم رحلة إلى حمص؟” قالت له بابتسامة ماكرة: “نعم!” سألها: “متى أقرب رحلة لديكم؟” قالت له بغنج مستفزّ: “إيمتى ما بدك عندنا رحلة لحمص!” وهنا غضب منها عبد الكريم، وقال لها: “شو، أنا عم بمزح معك؟” فردت عليه: “يا أخي، أنت بحمص!”
لم يتزوج عبد الكريم إلا بعد أن تقاعد وبلغ الثانية والستين تقريباً. وكنت قبل ذلك كلما سمعتُ من صديقنا المشترك هيثم أن عبد الكريم لديه نية للزواج بادرت بالاتصال به وسألته عن ذلك، وكان دوماً يقول لي إن المشروع فشل. وفي إحدى المرات اتصلت به من الطائف وهو في اللاذقية، وبعد أن سألته عن الصحة والأحوال، سألته إن كان قد تزوج. فقال لي: “لا، والله!” ولما سألته عن السبب، قال مازحاً: “نسيت!”.
في ربيع سنة 1996 (إن لم تخني الذاكرة)، أرادت إحدى الموظفات الإداريات في كلية الآداب بجامعة تشرين إصدار مجلة حائط، وطلبت منا أن نُسهم في إنجاح هذا المشروع بالكتابة في المجلة. اعتذرتُ منها بذريعة لم أعد أتذكرها، لكنني في قرارة نفسي استسخفت فكرة إصدار مجلة حائط بدائية في عصر التكنولوجيا الرقمية! وبعد إلحاح شديد من الموظفة، وافق عبد الكريم أن يكتب لها مقالة عن شعار “ربط الجامعة بالمجتمع” الذي كان رائجاً في تلك الأيام، ولعل صاحب الشعار كان حافظ الأسد نفسه. باختصار، كتب عبد الكريم مقالة (بحس فُكاهي مبطَّن) خَلُصَ فيها إلى أن باصات السرفيس الصغيرة هي الوسيلة الوحيدة التي تربط الجامعة بالمجتمع! لا أعرف كيف نجا عبد الكريم من الاعتقال حينها.
جرأة بلا حدود
ومن الطرائف التي رواها لنا عن خدمته الإجبارية في أمن الدولة في سبعينيات القرن الماضي أن رئيسه في الفرع (وكان برتبة عقيد) قد أبلغه ذات يوم أنَّ عليه أن يستعد ليكون غداً من ضمن فريق الحماية لاستقبال العقيد معمر القذافي في مطار دمشق. سعى عبد الكريم إلى أن يُعفى فلم يقبل العقيد اعتذاره. ولما جاء الليل، لفَّ عبد الكريم قميصه وبنطاله ووضعهما تحت وسادته، ثم نام عليهما. وفي الصباح لبسهما (من غير كيٍّ) ثم انتعل شحاطة بلاستيك (أم إصبع)، وتوجَّه إلى المطار. ولما رآه العقيد بهذا المظهر الكاريكاتيري المُضحك الذي لا يليق باستقبال ضيف سوريا الكبير، راح يشتم ويلعن، وأمر عبد الكريم أن يجلس (أو يتوارى) في سيارة قابعة على أرض المطار وأن يُمسك بجهاز اللاسلكي وينتظر التعليمات إن حدث طارئ. ادعى عبد الكريم أنه لا يعرف كيف يُمسك باللاسلكي، فازداد غضب العقيد وأمره أن يغرب عن وجهه. ومن هناك توجه عبد الكريم إلى محطة الباصات في دمشق ثم منح نفسه إجازةً من عدة أيام قضاها في حمص.
وسأختم هذا القسم بذكر إحدى طرائفه الأكاديمية. التحق عبد الكريم بكلية المعلمين في حائل في المملكة العربية السعودية (في مطلع الألفية)، وكان من جملة ما درَّس مادة الإنشاء. ولما صحح أوراق الامتحان النهائي كانت نسبة الرسوب عاليةً جداً، فرفض رئيس القسم اعتماد النتيجة. ولكن عبد الكريم أصرَّ على موقفه، وبيَّن لرئيس القسم سبب رسوب معظم الطلاب لديه في تلك المادة. قال إنه طلب من الطلاب أن يكتبوا موضوعاً (من الخيال أو الواقع) عن رجل كان لديه مشروع عظيم أو حلم كبير، لكنه فشل في تحقيقه. فانقسم الطلاب إلى قسمين: قسم كتب عن النبي محمد (صلى الله عليه وسلم)، وقسم كتب عن الملك عبد العزيز! بُهِت رئيس القسم بهذا الجواب. فسأله عبد الكريم مداعباً: “ما رأيك الآن، هل نتصل بالمخابرات أم بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟” فأقر رئيس القسم النتيجة كما هي.
قدرة تحمل استثنائية
حين حصل عبد الكريم على عقد عمل في الكويت قبل الالتحاق للعمل في جامعة تشرين، عذله بعض أصدقائه عن الذهاب بدعوى أنه ـ وهو ابن حمص المعروفة باعتدال جوها الصيفي ـ لن يستطيع العيش في الكويت وحرِّها اللاهب. فقرر أن يختبر نفسه، فصعد إلى سطح بيتهم بعز الظهر في الصيف، وتغطى بعدد من البطانيات (أظنه قال ثماني بطانيات)، ونام قريرَ العين هانيها. اجتاز الاختبار بنجاح.
ومما شهدتُه بنفسي عن جَلَده كان في صيف 1998 أو 1999. دعانا يومها صديقنا العزيز الآخر د. محمد علي حرفوش إلى غداء متأخر (سمك مشوي) في الشاليه الذي يملكه على شاطئ البحر شمال اللاذقية. وكانت النية أن نسهر في الشاليه ونبيت هناك. نمنا نحن “ثالوث العُزَّاب” في الصالون. لكن فاجأتنا أسراب من الناموس لم أذق مثل لسعاتها السامة في حياتي. نام عبد الكريم غير آبهٍ بلسعات الناموس، وكان يسخر مني ومن هيثم لأننا سمحنا لحشرات صغيرة أن تُكَدِّر نومنا! في الحقيقة، بقينا ساهرَيْن طوال الليل.
وبعد أن تجاوز الخمسين كان يحرص على رياضة المشي حتى يُجهِد نفسه. ولما كان في مدينة حائل السعودية رآه رجل سعودي ذات يومٍ والعرق يتصبب منه والإجهادُ بادٍ عليه، فظن أنه وافد مسكين، فأشفق عليه الرجل الكريم وعرض عليه مساعدة مالية (أياً كان المبلغ) وألا يبتئس بظروف المعيشة!
كما أخبرني هيثم أن عبد الكريم رفض في الأيام الأخيرة من حياته أن يأخذ حقنة مورفين لتخفيف ألمه. ألهذا الحد يستطيع إنسان أن يُكابر على الألم ويتجلَّد؟
وكنا نعجب من قدرة عبد الكريم على الاستحمام بالماء البارد حتى في عزِّ الشتاء. ومن كثرة ما ألححنا عليه ذات يوم شتائي قارس في اللاذقية أن يستحم بماء دافئ على الأقل، رضخ لنصيحتنا. لكنه أتى إلى الجامعة في صباح اليوم التالي وقد أُصيب بالزكام في اليوم نفسه، وأقسم ألا يستمع إلينا مرةً أخرى. ومنذ أنه عرفته منذ ثلاثين سنة، لم أسمع أنه مَرض إلا في تلك المرة، وفي الصيف الماضي. وحين زارني في الرّقة في صيف 2011، كان عمره 58 عاماً، ولم يغزُ الشيبُ شعر رأسه. وكان أيضاً نباتياً لا يأكل من اللحوم إلا السمك. لكنه حين زارني، كسر القاعدة وأكل لحم خروف طرياً.
رحيل بلا وداع
فجأةً، تسلل إليه المرض الخبيث بصمت، فأكل كتلته العضلية بسرعة مرعبة، ونخر جسده، وأحاله إلى كتلة ضئيلة من العظام.
مات عبد الكريم خلال أشهر قليلة من اكتشافه المرض. ومن عجبٍ أن لحظة مماته كانت في يومين مختلفين بسبب فارق التوقيت. فقد مات في أول يوم من شهر كانون الأول بتوقيت سِدني، وفي آخر يوم من شهر تشرين الثاني بتوقيت دمشق. هكذا توزعت ساعة مماته على قارتين. مات وهو يبكي فراقَ الأحبَّة ونأيَ الديار.
حزنتُ لموته، لكنني لم أستطع أن أبكيه. لا أعرف لماذا. ربما لأنني بكيته قبل أسبوع من وفاته ـ واستنفدتُ دموعي يومها. ليس في الموت سمة مميزة، إنما التميز في قصص بعض الأموات. هكذا كان عبد الكريم: متفرداً في مماته كما كان متفرداً في حياته. لا أُجيد التفجع ولا التأبين ـ فلطالما أطربنا الراحل بصوته الرخيم وهو يردد بيت المعري عن عبثية التفجُّع:
غَيْرُ مُجْدٍ فِي مِلَّتِي وَاعْتِقَادِي … نَوْحُ بَاكٍ وَلَا تَرَنُّمُ شَادِ
إنما أردت أن أذكر شذراتٍ من حياة الراحل لمن لا يعرفه. ومعذرةً منك، أبا ورد، عن أي تقصير غير مقصود. طِبتَ حياً وميتاً: فقد ملأتَ قلوبنا بمحبتك، وأوجعتها بفراقك.
*كاتب ومترجم سوري مقيم في إسطنبول
2 كانون الأول 2025