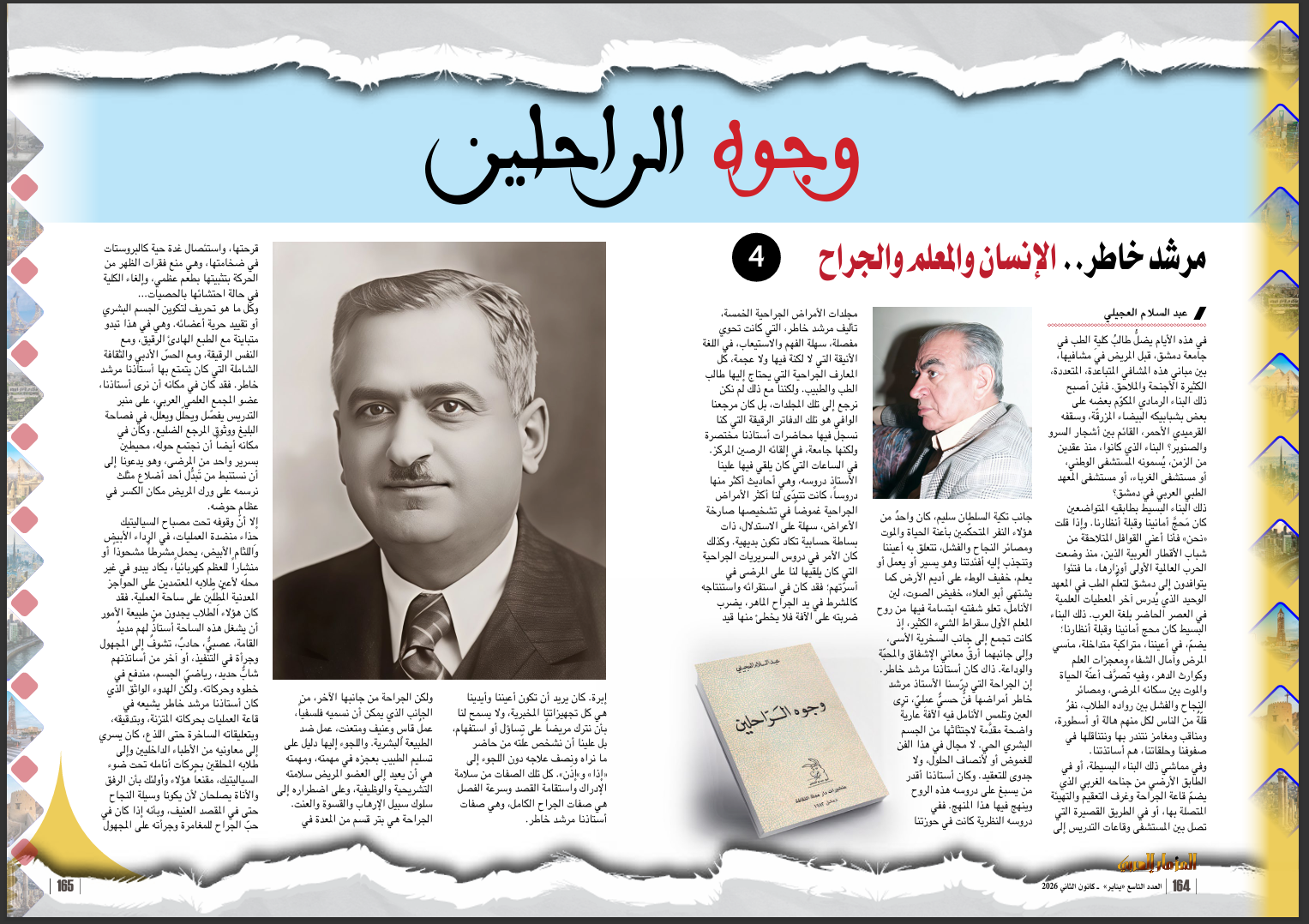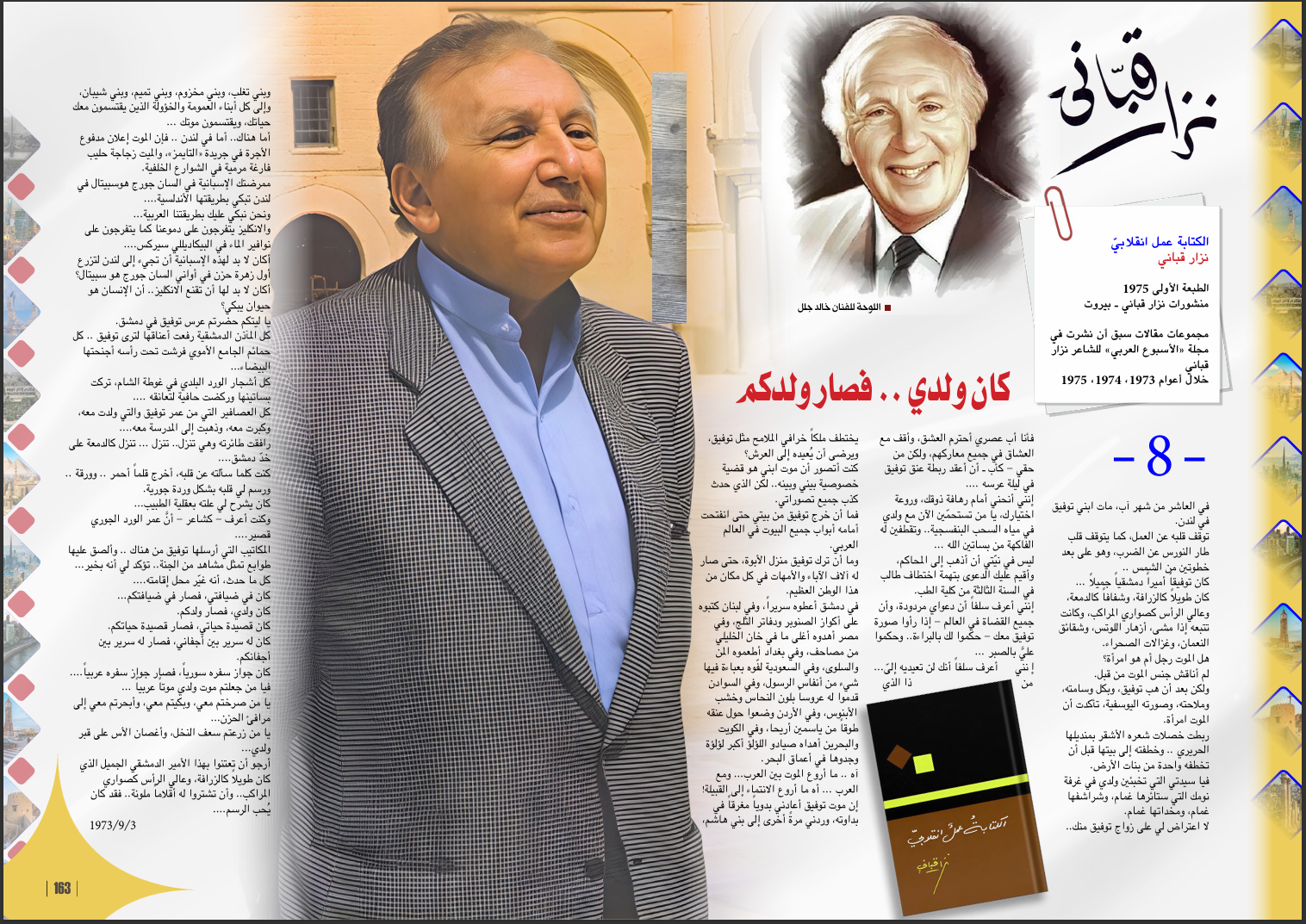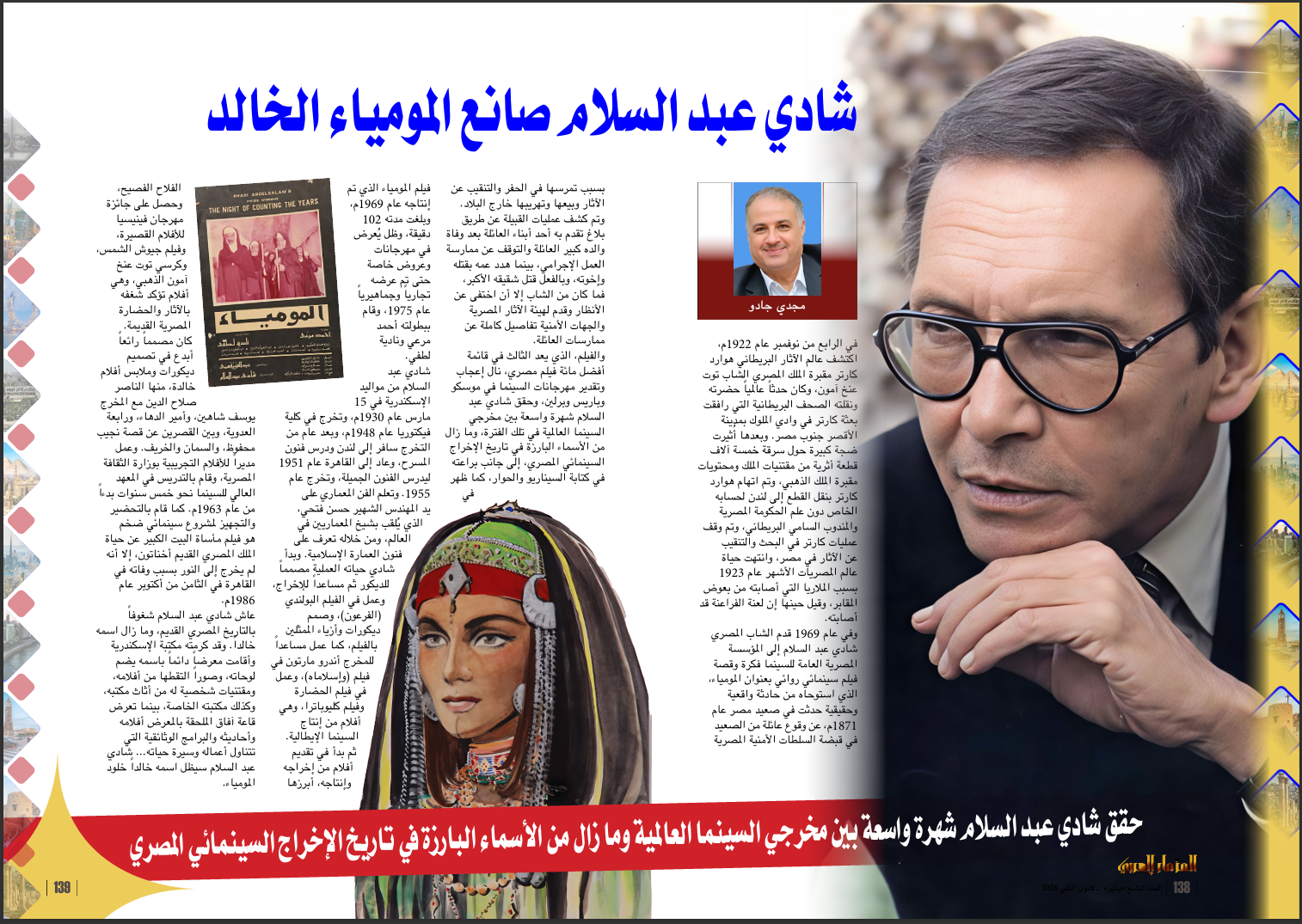كيف يمكن توطين الثقافة؟

ياسين طه حافظ
التوطين مفردة غالب انتمائها الى الاقتصاد والشأن الاجتماعي، فهي أكثر استعمالاً هناك مما هي في عموم مشاغل الحياة، كتوطين النازحين او توطين الرحّل. وهنا توطين الراتب او توطين مبلغ او كلفة المقاولة أو المشروع.
ما يهمني اليوم هو الأحدث والأبعد من هذين، وهو توطين الثقافة. وهنا ايضاً نكون امام معنيين. واحدهما جعل الثقافة، أو المثقف، كاتباً او مفكراً وطنياً. اي من سكنة ومن اهل الوطن. او من العاملين من اجله ولأجل حريته وخيره.
والمعنى الثاني هو ما صنعه الاقتصاد بالأموال. بمعنى اختزانه او ايداعه في مكان امين، يحتفظ به حتى حين يستحقه صاحب شركة او مقاولة او وريث او فريق عمل او موظف. لكن كيف نوطّن الثقافة؟ واية الوسائل المتاحة لفعل ذلك، بقدر مقبول من السلامة والنجاح؟
الثقافة إما مطبوعة على ورق، او مرسومة او منحوته او مسجلة على اشرطة او اقراص. والرسم كما هو، معلوم، إما مرسوم على لوحات او مطبوع او منسوج على أقمشة او منسوجات صوفية او قطنية او على ورق من نبات يصلح لذلك. وليس للثقافة الشفهية غير التسجيل والذاكرة. وفي هذين يعتورهما ما هو معروف وما هو غير متوقع من الضرر والتأثير.
السؤال المهم بالنسبة لنا، بعد هذا، هو:
كيف يمكن توطين الثقافة، ومن يضمن او يوفر سلامة التوطين؟ وكيف يمكن تحديد الزمن الذي يطاول فيه التوطين ويحتفظ بما وطّناه؟
في الحديث عن ثقافة العالم نحتاج الى سعة افق غير ذلك الذي للثقافة المحلية او الثقافة الوطنية. لان ثقافة العالم مكتوبة بلغات مختلفة وعديدة. ونحن لا نستطيع ان نخضعها الى نظام آلي. لان اللغات ليست دائما ذوات نظام واحد. انظمة هذه اللغة غير ما لتلك. المتغيرات كثيرة سواء في مواقع الفعل او المفعول به او الفاعل او الصفات احيانا، فضلا عن اللواحق.
نعم، قد تقع لغتان او ثلاث على نظام واحد. لكن هذا لا ينطبق على جميع اللغات. هل يؤثر هذا في التوطين؟ نعم، اذا احتجنا للنظام الالي لتسجيلها ولتلافي اي خطأ او ضرر في اثناء العمل او النقل او الحفظ. يتعذر، التوطين بلغات مختلفة. لانه يوجب جهودا مضاعفة، ولا يتسق والعمل التجاري الواسع ولا لمشاريع واسعة مما يتطلبه عصرنا.
معنى كلامي، تعذر اخضاعها لبرنامج واحد يمكن ان يجتذب اعدادا مقنعة تجاريا من المستهلكين. إذاً انتفى الربح، بل واضحة هي الخسارة، خسارة الشركة المنتجة او الجهة المنتجة. وليس ممكنا ايضا ان تتعدد الانظمة، اليا. فذلك اولا غير تجاري كما قلنا، ولا يخلو من تداخلات واخطاء وارباك. وطبعا هذا ما يحصل عادة، او كثيرا، في الترجمة الالية.
هذه الاخطاء تجعلنا لا نعتمد الترجمة الآلية، لا في ترجمة الوثائق ولا في ترجمة النصوص الابداعية. هي غالبا تعتمد عندما تكون القيمة اهم من الاسلوب. وعندما تستسهل اللامبالاة بجماليات البلاغة. كما ان السياقات غالبا تفقد سائغيتها ويحل التراكم محل السياقات (الاتفاقات الاسلوبية)، او قل (السياقات المتآخية). رفعة الاسلوب، السمو، ليس قضية بالنسبة لمستخدمي الترجمة الالية.
من جانب آخر، الترجمة البشرية او العقلية ليست واحدة. هي تتفاوت حسب ثقافة وذائقة وروح او مزاج المترجم. هذه الحال الثانية، صعب ائتمانها على توطين نص صعب ومختلَف عليه. ولا حتى على وثيقة او حدث عسكري او مدني، ولا على مُسهمين في قضية او شهود عليها. ثبات المعنى وعدم قلق الدلالة والتوافق على المفهوم، غير ممكن. صعب في مختلِف الاحوال توافره.
مسألة اخرى لا بد من ان نحسب لها حسابا. اشرنا لها مسرعين وعبرنا. تلكم هي اننا نعمل في عالم تجاري متسارع. هذا يستوجب انهاء اي عمل بأقل كلفة وبأسرع وقت. الوقت مال! وشعار رأس المال المعولم اليوم: الارض سوقنا.
اذن الترجمة لحفظ او توطين نص ادبي او وثائقي او وصف مشهد او حدث، يستوجب سرعة انجاز. سرعة الانجاز تقول للمترجم، او جماعة المترجمين: “هكذا كفى، لا وقت لنا، لننهِ الموضوع!”
هنا العمل لم يأخذ وقته الكافي للدقة والاتقان. السرعة على حساب الكمال. كما لم يحظَ بالمراجعة المتأنية او اعادة النظر. وليس لنا جهاز مراقبة يحدد مدى الجودة او مدى الدقة او حسن الانجاز. ثم ان الكلام، او النص على الورق، هو في حال، وعلى الشاشة في حال، وفي التسجيل في حال. معنى هذا انه في احوالٍ كثيرة لا وجود، راسخ او ثابت او طويل الامد، له. يقابل ذلك وجود مضمحل او سريع الزوال لا يسمح بمزيد من التمعن.
أخلص من هذا العرض، او هذه الامثلة، الى ان النصوص المدوّنة والنصوص المسجلة والمرئيات، لا تستقر، كما هي، في التوطين. وان توطين ثقافتنا للمستقبل لا يضمن سلامتها الكاملة ولا كل حقيقتها، او كل معانيها، او كل جمالها.
اقتصر كلامي حتى الان على توطين الكتابات او على المكتوب من ثقافتنا. قد تسلم الارقام لحدٍ ما مادياً، لكنها لا تسلم قيمةً وعلاقاتٍ وعائديات. وما دمنا غالباً نترجم مادة ثقافية الى لغة التوطين الاوسع، يجب الّا نغفل الفرق الاكيد بين المترجم الالي والمترجم الحي.
المترجم الحي بإنسانيته، متغير ذاكرةً ومزاجا وتأثراً بواقع. هو نفسه قد يعيد ما كتبه. يعيد كتابة السطر نفسه والقول نفسه بصيغة وطريقة اخريين.
نحن لن نُقرَأ في المستقبل قراءة اليوم. كما اننا لا نَقرأ اللوح المسماري كما كتبه وقرأه او قاله اهله تماما. تفوتنا موسيقى الحرف، سلاسة حال السياقات والدلالة الاولى. نحن نقرأ اللوح اليوم شبه قراءة. تظل قراءتنا تقريبية مهما كانت في رأينا دقيقةً.
علينا الاقرار ايضا بمدى حيوية الذاكرة وعدم ثبات التصنيع التقني والوسائل والاجهزة المنفِّذة. كل ذلك قد يُفضي الى عدم الضبط. وقد يؤدي الى إحلال النوادر والاسطورية محل الحقائق. وقد لا نعرف تماما علامَ تدل الارقام…