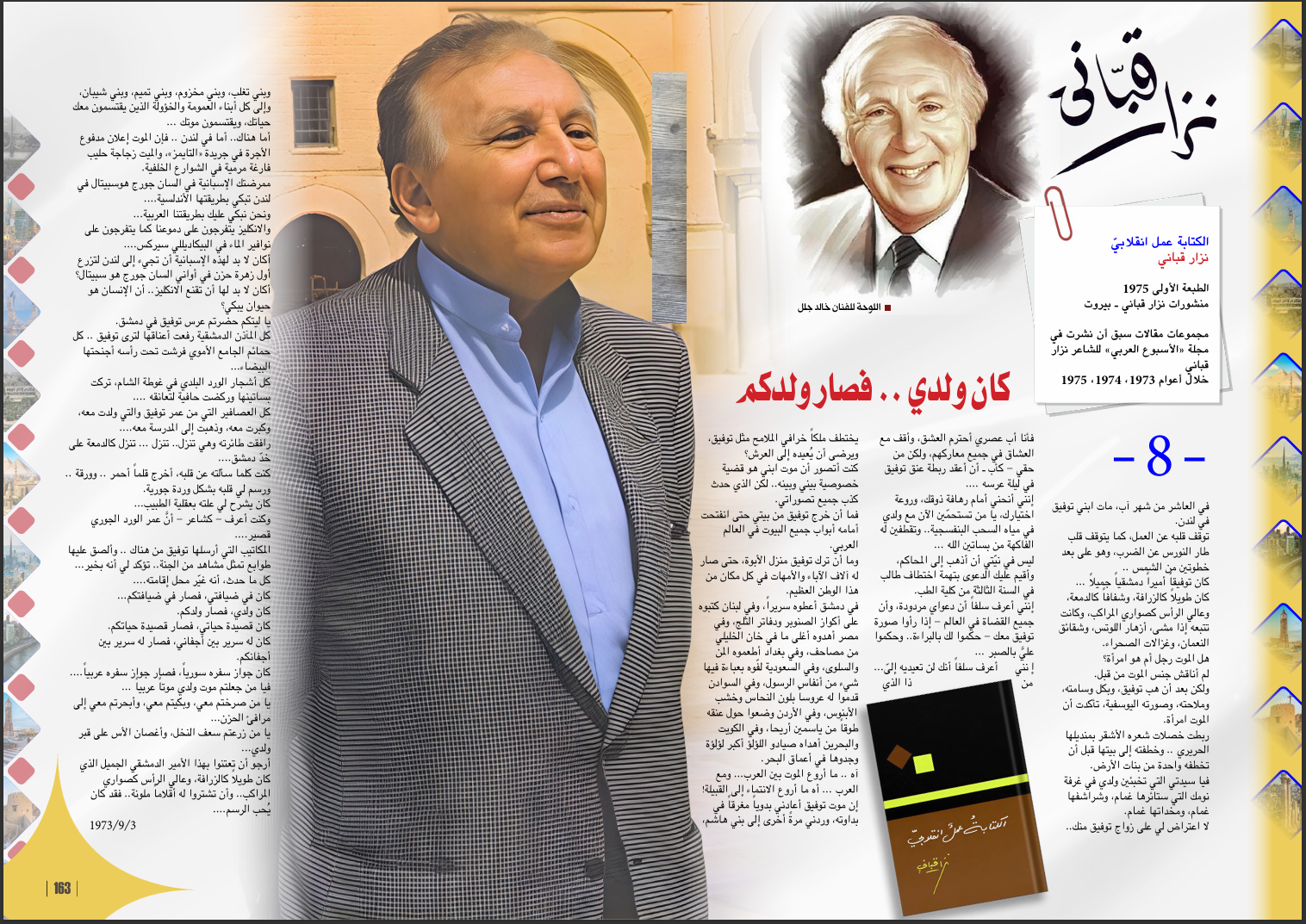العجيلي حكّاء الفرات الخالد

عبد الكريم البليخ

لم يكن عبدالسلام العجيلي مجرد كاتب، ولا طبيباً فحسب، ولا سياسياً عابراً في تاريخ الحياة العامة السورية، بل كان في كل ذلك تجسيداً نادراً لنموذج المثقف العربي الذي لم يقبل أن يُختزل في حقل واحد. عاش حياته كمن يعبر جسراً طويلاً بين ضفتين: ضفة الفرات بذاكرتها الشعبية وأساطيرها ونكهتها الخاصة، وضفة العالم الحديث بجامعاته، ومجلاته، وندواته، وصراعاته السياسية. ومن هذه الحركة المستمرة بين الضفتين وُلدت نصوصه وقصصه ومقالاته، ومعها صورته كأديب “متعدّد المواهب”، هاوٍ كبير مارس كل شيء بروح العاشق لا بروح الموظف المحترف.
من ينظر إلى بدايات العجيلي في الرّقة، لا يستطيع أن يغفل دور المكان في صياغة وجدانه. الرّقة لم تكن مجرد مدينة صغيرة على الضفة الشمالية للفرات، بل كانت ذاكرة حيّة تختزن أصداء الأمويين والعباسيين، وقوافل التجار، وحكايات الرواة. كان الفرات بالنسبة له نهراً يتدفق بالحياة، يهب الأرض ماءً ويهب الإنسان أساطير. على ضفافه نشأت أولى الحكايات التي حفظها من أفواه الجدات، وهناك تعلّم كيف يُصغي إلى الأغنية الشعبية، إلى أصوات الموال، إلى نداءات الباعة، إلى موسيقى الحياة اليومية التي تحولت فيما بعد إلى نسيج أدبي في قصصه.
في تلك البيئة الفراتية، تلاقى التراث الشعبي مع التراث المكتوب. كان الصبي يحفظ الشعر العربي القديم كما يحفظ الأمثال الفراتية، يتذوق بلاغة امرئ القيس كما يتذوق بلاغة حكمة عجوز في مجلس سهرة. هذا المزج بين “العالي”، و”البسيط”، بين المكتوب والمنطوق، هو ما سيعطي كتاباته نكهة خاصة لاحقاً، نكهة لا نجدها عند كثير من أبناء جيله.
حين انتقل إلى دمشق لدراسة الطب، بدا وكأنه يبتعد عن بيئته الأولى، لكنه في الواقع كان يوسعها. في كلية الطب، تعرّف على عالم الجسد والمرض والألم، لكنه ظلّ ينظر إليه بعين الأديب. الطب بالنسبة له لم يكن علماً جافاً، بل قصة أخرى من قصص الحياة، حيث يلتقي الأطباء بالمرضى في مسرح يومي مليء بالمفارقات الإنسانية. كان يُمارس الطب بروح “الهاوي”، أي بروح المحبّ، يرى في كل حالة مريض حكاية تستحق الإصغاء، كما يرى في كل جسد عالماً يختزن أسراراً.
ولم يكن يفصل بين الطب والأدب، فالأول يغذي الثاني والثاني يغني الأول. الطبيب يحتاج إلى خيال لفهم معاناة المريض، والأديب يحتاج إلى دقة الطبيب في التقاط التفاصيل. ولذلك نرى في قصص العجيلي حساً نفسياً عميقاً، كأنه ثمرة من ثمار تجربته الطبية.
مع أن العجيلي لم يكن يسعى إلى السلطة، إلا أن السياسة فرضت نفسها عليه. انتُخب نائباً، وتولى حقائب وزارية، وشارك في جيش الإنقاذ عام 1948 دفاعًا عن فلسطين. لكنه ظلّ ينظر إلى السياسة بعين الناقد، لا بعين المتورط كليًا. ربما مارسها، لكنه لم يتركها تبتلعه. ظلّ في أعماقه أديباً حتى وهو يجلس على مقعد وزاري. كتب عن السياسة كما يكتب عن الأدب، بعين من يرى المفارقات والتناقضات.
السياسة عنده لم تكن مهنة، بل كانت ساحة اختبار جديدة للهواية الكبرى: هواية الحياة. ومثلما مارس الطب والأدب بروح الهاوي، مارس السياسة كذلك، غير مقيد بالبراغماتية الباردة، بل مدفوعاً بمثالية المثقف الذي يريد أن يغيّر ولو قليلاً.
يُعتبر عبدالسلام العجيلي واحداً من رواد القصة القصيرة العربية. قصصه تفتح نافذة على عالم متشابك من البشر، تُظهر ضعفهم وقوتهم، تناقضاتهم وأحلامهم الصغيرة. لقد تأثر بالسخرية التي أحبها في بداياته، لكنه مزجها بعمق نفسي واجتماعي. المفارقة هي قلب قصصه: الطبيب الذي يعالج ويخطئ، السياسي الذي يعد وينقض، الفلاح الذي يكدّ ويُخدع، العاشق الذي يسعى ويُخذل. كلها وجوه لحياة مليئة بالتناقض، لكنها في النهاية حياة تستحق أن تُروى.
من يقرأ كتاباته يكتشف أن المدن بالنسبة له ليست مجرد أماكن، بل شخصيات. كتب عن الرّقة كما لو أنها إنسان حي، له ذاكرة ونَفَس، له حب وعناد. كتب عن تدمر وكأنها أميرة منسية تنتظر من يوقظها، وعن الرها كأنها مدينة تحرس أسرار التاريخ. العمارة بالنسبة له لم تكن حجارة جامدة، بل حكايات متجسدة في الحجر، كل قوس يحمل قصة، وكل سوق يحفظ أصوات الباعة والأمهات.
هذا الحس المعماري في كتابته جعله قريباً من المؤرخ، لكنه مؤرخ بلغة الأدب. لم يكتب عن المدن كما يكتب الباحث في التاريخ، بل كما يكتب العاشق عن حبيبته.
لقد عاش العجيلي في القرن الذي عرف فيه العرب صراعاً هائلاً بين التراث والحداثة. لكنه لم يرَ في هذا الصراع خصومة مطلقة، بل حواراً يمكن أن يُغني الطرفين. كان ابن التراث العربي بحق، يحفظ الشعر القديم والأمثال، لكنه في الوقت ذاته قرأ الأدب الغربي الحديث. لم ينغلق على ماضٍ ذهبي، ولم يذُب في حاضر غربي، بل حاول أن يصنع توليفته الخاصة: أن يكون عربيًا معاصرًا في آن واحد.
خلال وجوده في البرلمان والوزارة، لمس العجيلي بوضوح أهمية الاقتصاد والتعليم. كان يعرف أن سوريا لا يمكن أن تبني مستقبلها دون جامعة قوية، دون طبقة وسطى متعلمة. ولهذا ظلّ يشدد على قيمة التعليم، على ضرورة أن يكون للثقافة دور مركزي. من هنا نفهم علاقته بالمجلات الأدبية العربية، مثل “الدوحة” و”الديار”، حيث نشر مقالاته، ليس من باب الشهرة، بل من باب الإيمان بأن الكلمة جزء من مشروع نهضة أوسع.
الرحلة كانت عنده أكثر من هواية. سافر إلى بلدان عدة، شارك في ندوات ومؤتمرات، لكن السفر عنده لم يكن مجرد انتقال جغرافي. كان كل سفر مناسبة لإعادة التفكير في الذات. كان يرى في باريس أو بيروت أو بغداد انعكاسات لمدينته الرقة، يبحث عنها في كل مكان. ولذلك فإن كتاباته عن الرحلة هي في جوهرها كتابة عن الذات.
رحل العجيلي تاركاً وراءه إرثاً غنياً، ليس في الكتب فقط، بل في صورة الإنسان الذي عاش بروح هاوٍ كبير. كتب القصص، مارس الطب، خاض السياسة، كتب التاريخ والفلكلور، أحب مدينته الرّقة وكتب عنها، عاش الحياة بكاملها.
إنّ الحديث عنه اليوم ليس مجرد استعادة لسيرة أديب راحل، بل هو استعادة لفكرة المثقف العربي في أبهى صورها: المثقف الذي لا يكتفي بالقراءة والكتابة، بل يعيش بين الناس، يمارس السياسة، يعالج المرضى، يكتب عن المدن، يسافر، ويحاور العالم. المثقف الذي يجعل من حياته نصاً، ومن نصه حياة.
العجيلي هو ابن الفرات، وابن الرّقة، وابن التراث العربي، وابن القرن العشرين المليء بالعواصف. لكنه قبل كل ذلك ابن “الهواية الكبرى”: هواية الحياة نفسها.